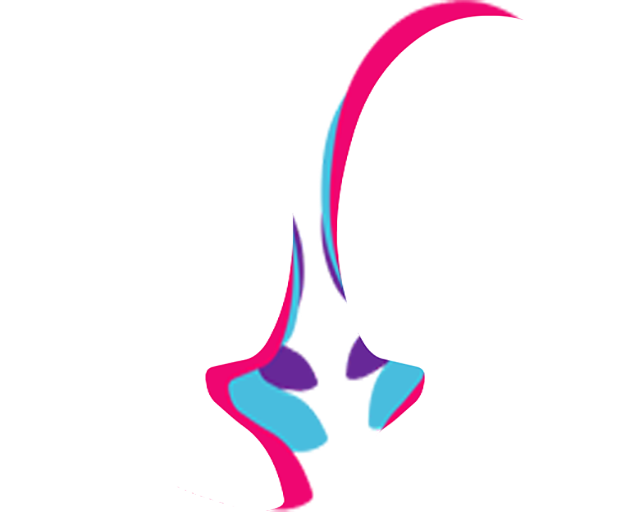لم يمر فيلم “حرائق” السوري لمخرجه وكاتبه محمد عبد العزيز مرور الكرام في المهرجانات العالمية. حيث حصل على جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان روتردام، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبعد دورانه حول العالم لثلاث سنوات تحنّ الحرائق للمكان الذي شبّت منه “سوريا” وتبدأ استعراض نيرانها للجمهور ولكن بلغة الفن السابع وليس بلغة الموت.
في العمل قصص مختلفة لنساء شابات عانينَ من مآسي الحياة وحربٍ طال أمدها، فيخوض المخرج بتفاصيلهن في يوم واحد فقط ضمن ساعتين سينمائيتين مرهِقتَين, مكرراً تجربة اليوم الواحد للأحداث بعد “المهاجران” و”الرابعة بتوقيت الفردوس” وإن دار حول المكان الواحد دون اختصار الحدث فيه لكنه كان المكان الوحيد المعلن في الفيلم “سينما السفراء” في شارع ٢٩ أيار.
كثافة الترميز في الفيلم تدعونا للتركيز في كل مشهد، فلم يترك محمد مشهداً دون أن يوصل فيه رسالة مبطنة تعتمد على دقة المشاهد في التقاطها، فنجد أنفسنا أمام دجاج يحترق ويُسلَخ على صوت التكبير كحالنا تماماً وكأننا نتشارك معه الصفات نفسها في هذه الحرب الخَروب. ومن قلب نتف ريش الدجاج يحترق حب الصبية العاملة في المدجنة التي تنتظر حبيبها ليأتي ويخلصها من رجل عجوز اختارته لها أمها الملأى بتجاعيد الزمن وكأنها ترمي ابنتها في ذات المرجل القاسي الذي رُميت فيه قبل عقود، فنرصد خطاً ريفياً حلمه بسيط يتم تحقيقه على”ميتور” يستقله العاشقان للهرب نحو عالم يتكوّم في سينما مهجورة داخل مدينة دمشق الغاصة باحتراقها، ليشتعل الجنس على سطحها وتختبئ عورة العريس الشاب بخريطة العالم، ثم يُساق بعد مضاجعة زوجته التي شهد أبطال بوسترات الأفلام على زواجها، فقد جاءت والدتها بالشرطة لمعاقتبه على اختطاف الفتاة. خط سينمائي مشبع بالبساطة والحلم اليافع لكنه مليءٌ بالوجع، فما كانت نتيجة التمرد هذا إلا الخذلان وما أكثر خذلان الشباب في حرب وجدنا أنفسنا فيها دون أن ندري.

تعترض مشهد العاصمة النازف امرأةً تخرج توّاً من السجن لتهربَ من سجن آخر عنوانه القتل الذي قد يقع عليها من شقيقها بعد أن تمردت على عائلتها وتزوجت وأنجبت، فكانت “خولة” خط العمل اللاهث للوصول إلى بر الأمان. وقد انتقلت اللقطات مسرعة معها في قلب حارات الشام المكتظة التي ركضت فيها هاربةً من شقيقها حتى تصل في النهاية إلى طفل صغير هو ابنها الذي يشير إلى بلوغ بر الطمأنينة، لكن فَشَل الأخ الأول في قتلها أعطى المهمة للثاني وكأن الدم يأبى إلا أن يسيل.

وفي ضفة أخرى نشهد فتاةً تقطن أحد الأحياء الثرية من العاصمة، تكوّن في بطنها الجنين حديثاً من خطيبها الرسام الذي رفض ابنه قاطعاً. فما كان من خطيبته إلا أن ركعت باكيةً فوق اللوحة الحمراء التي يرسمها لتكون الخطوط المرسومة تحتها كدماء جنين لن يكتمل. ورغم عدم إشباع هذا الخط أمام الخطوط الأخرى إلا أنه أكمل توصيف معاناة المرأة بين حلم الأمومة وفرض الزواج ومعاناة الاختيار.

فارتسمت الحرائق التي لم تبدأ من الحرب، فشرارتها ولدت في المجتمع السوري قبل ذلك بكثير إلا أنها وجدت في انعكاسات الحرب مساراً أكثر ألماً للظهور، وذلك من خلال رصد تجارب على تماس مباشر بالحرب. الأولى فتاة في عمر المراهقة تفقد أهلها بعد أن تنجو من القصف، فتخرج من تحت الخراب باهتزاز وفقدان جعلها في حالة من عدم التصديق ومناداة أهليها بشكل جنوني. بينما يظهر النموذج الثاني حول مُجنّدة في تنظيم متطرف يقنعها قائد العملية أن تفجير نفسها سيوصلها للقاء طفلَيها اللذَين لقيا حتفهما في الحرب. ملامح الضياع إذاً تجد نفسها في ضحايا الحرب بينما تعاني بطلات العمل الثلاث من خشية الفقد حبيباً كان طفلاً أم جنيناً، انطلاقاً نحو ذروة محتملة تتداخل الخطوط وتحيط في سينما السفراء والشوارع الفرعية المحيطة بها، شوارع خلفية لطالما رمّزت سينمائياً للتمرد وجدت مساقها في الفيلم للهرب للُّهاثِ من تبعات الموت وللنجاة كما للمصير الغامض، حيث تخطو المجندة بحزامها الناسف فتغافل القائد وتصعد بناءً قيد الإنشاء وسط العاصمة، لن تفجّر السينما إذاً بل سيبلغ الحريق السماء ويفتح قبو السينما بابه لقائد العملية الإرهابية بالغاً العمق حيث ترسم الخطط وتنفذ على السطح. تكثر الأسطح حقاً في سينما عبد العزيز فعلى سطح سينما السفراء عالم خاص ببشر قاطنين وسط دمشق بالقرب من دوائرها الرسمية. وعلى سطح البناء غير المكتمل ستنتهي الحكاية بانتظار انتهاء شريط العرض المحترق الحواف في صالة العرض الكبرى.. سوريا.

نشهد في العمل إذن سلسلة أحداث أبطالها نساء استطاع عبد العزيز رسم شخوصهنّ بدقة، ليجولَ في عوالم غريبة أخبرتنا عن سحق الحرب، فنجد أطفالاً يأكلون من طبق رُسِمَت عليه خريطة الكرة الأرضية التي نشاهدها تحترق نهاية العمل بنار احتراق الدجاج ذاتها في إشارةٍ لتسخيف العالم الذي لا يقدم لأطفاله سوى بضع لُقيمات غير كافية ولا يستر العورات حتى، أما”السوبر مان” الذي نحلم بوجوده لإنقاذنا من سعير النار فقد جعله محمد مختلاً عقلياً وكأن الأمل بالخلاص هو أمل ضعيف، مجنون، وربما وهمي. لكن رغم اتزان العرض واللقطات العظيمة والإسقاطات القوية فإن ما يعيب الفيلم مقدمة طويلة لم ترسم ملامح الشخصيات بسرعة، حيث استغرقت ما يقارب ثلاثة أرباع الساعة حتى عرفنا تقريباً ما يجري ولماذا يجري، كما أنه من الواضح أن الفيلم بترميزه ودلالاته موجه لفئة وشريحة معينة من الشعب وهم المثقفين والنّقّاد والفنانين، ففي حال افترضنا أنّ شخصاً بسيطاً غير مُلِمّ بالأعمال السينمائية وهذه الرموز الإخراجية القوية “وهي الفئة الغالبة في المجتمع” أراد مشاهدة الفيلم، فإنه لن يستطيع فهم الأحداث وربما يخرج من منتصف الفيلم لأنه سيكون مملاً بالنسبة له، وبنظره سيبدو “حرائق”عملاً لم يقدّم قصةً واضحةَ المعالم رغم الأداء الرائع للممثلين فيه. كما أنه تتضح في بعض المشاهد عدم مراعاة تراتبية الأحداث حيث نقف أمام مشهد قوي مثلاً فيتم قطعه ليُعرَض بعده خمسة أو ستة مشاهد ثم نعود لذاك المشهد و كأننا تركناه تواً و كأن الزمن لم يمضِ فيه، وربما ذلك يعود إلى أن الأحداث تدور كلها في وقت واحد إنما هذا جعل الجمهور يتوه في دائرة تسلسل زمني مرتبكة بعض الشيء.
لكن يبقى محمد عبد العزيز رجل الأفلام الصعبة الذي يقدّم خليطاً صعباً لكنه يسحر الوجدان ويغني السينما السورية بكثيرٍ من ألقٍ تفتقده منذ سنين عجاف.
لكن يبقى محمد عبد العزيز رجل الأفلام الصعبة الذي يقدّم خليطاً صعباً لكنه يسحر الوجدان ويغني السينما السورية بكثيرٍ من ألقٍ تفتقده منذ سنين عجاف.