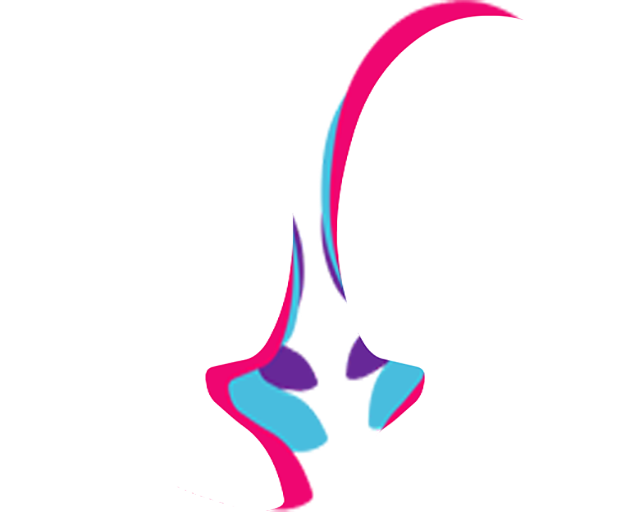بقلم: نورهان النداف
لا أفهم هذا التجرؤ على شرف الكلمة وشرف العقل؟
هل خلت الساحة إلا من مسودي الأوراق ممن يحسبون خربشاتهم رسما للشخصيات ومحاكاة للواقع؟
ومتى كان واقعنا لامعاً كعربات أبطال حكاياتهم؟ ومتى كان مزركشاً بشتى أشكال الترف وشتى معاني القرف؟
لست اليوم في معرض عتب على الممثلين السوريين فقد رفع عنهم إذا عرف السبب وبطل من تحولهم العجب. وليس لومي لكتاب تجرؤوا على الكتابة كأنها بائعة هوى تبذل نفسها للجميع برزمة من المال، بل إنني ألوم إذ ألوم أصحاب رؤوس المال الممسكين بتلابيب الصناعة ممن يستدعون القلم بالمال ويرسمون خطوطه على قياس السوق قاصدين من نتاجهم كثرة الطلب لا لياقة العرض.
لا أكون دقيقة لو شبهت هؤلاء ببائعي الخضار الذين يملؤون صناديقهم بالأصناف الرديئة والفاسدة ليغطون وجهها بالنوع الحسن الفاخر وربما أثار تشبيهي حفيظة الكثيرين، ولا أقصد به تشبيه الفن بسوق الخضار بل تشبيه صناعه بالفئة السيئة من بائعي الخضار على أن مهنة هؤلاء اليوم أكثر شرفا وأمانة من صناعة الدراما.
لا ينقص الوسط السوري ممثلين ولا كتاب ولا مخرجين إنما ينقصهم منتج الأفكار لا منتج البضائع، وحدها الأفكار تستطيع أن تمشي بالدراما إلى ما هو أفضل من السابق حيث تكون الفكرة هي صاحبة الكلمة في اختيار الأبطال وسيرورة الحدث خلافا لما يجري اليوم من نسج للحدث على مقاييس النجوم البياعين!
صارت الدراما مورد من استطاع إليها سبيلا يقضيها كفريضة شاقة على استعجال، فلا فيها روح البذل ولا رجع لصداها، وعلى قلة الأعمال المنجزة لهذا الموسم إلا أنها كافية لرسم معالم الواقع الفني في سورية.
وقد يقول قائل إن الحرب أفرزت هذا الانهيار الثقافي الذي انعكس على شتى مجالات الفن، وأقول بلى ولكن لا ينبغي أن تتحول أسباب الأمس إلى شماعات اليوم، نعلق عليها استسهالنا في كل شيء.
أما المكاسب المادية التي تشكل الهم الأكبر للصناع فلابد هي حاصلة حين يكون العمل مشغولا بذكاء وقوة من جميع النواحي شأنها شأن الأعمال السورية التي عبرت حدود الدول العربية جميعها بقوة الفكرة وشفافية الطرح، فالحسن يؤتى إليه ولا يؤتى به.
ولعل مشكلة الإنتاج الحقيقية تكمن في شراء النصوص على مقاييس الفنانين بدلا من انتقاء الفنانين على قياس النص، ليحل كل في مكانه المناسب لا في المكان الذي يوازي جماهيريته.
يبقى رفض الجمهور لهذا الوضع المتردي بذرة أمل لتتغير الحال إلى أحسنها، دون أن يعطي ذلك الحق في أن تنسب جميع الآراء للنقد ما لم تكن مستندة إلى مبادئ نقدية واضحة ومدروسة، فليست الذائقة أخت النقد ولا هو وليدها.
فهو كما قال قسطاكي الحمصي في منهله: (له من جزيل الفوائد إذا جاء من أهله، وما ينجم عنه من المفاسد إذا جعله الغبي عرض جهله).
فهو علم لا موهبة وهو نتاج قواعد وأسس لا انطباعات، وأين نحن من هذا؟ وأين ما نكتب من روح النقد ومبتغاه؟
وكما يضرنا أن يكون واحدنا إمعة لا يعول على رأيه كذلك يضرنا أن يكون واحدنا محسوبا على جمهور النقاد وما هو منهم في شيء، الأمر الذي يستدعي ألا نستسهل النقد وأن نتعامل معه بمسؤولية أكبر.
من جملة القول يمكن أن نعزو أزمة الصناعة الفنية إلى نقص الخبرة إن لم نقل انعدامها في شتى أدوات المُنتج، ابتداء بالإنتاج وانتهاء بشارة العمل، فلا دراسات أكاديمية تدعم مقومات النجاح وهو ما يخرج الأعمال في معظمها بصورة ملائمة للجو العام وإن لم تكن تحقق شروط النجاح كما لو كانت حفلات زفاف يزف فيها العروسان ولا شيء يعنيهما فيها غير دخول عش الزوجية ليبقى المدعوون مذهولين من هذا الضجيج غير المبرر مشاركين في الزغاريد والرقصات احتفالا بعرس يجمع عروسين غير متناغمين.
ويبقى هذا القول تجميعا لحقائق لا يدعى فيها النقد وإنما دافعها الحب أولا وأخيرا