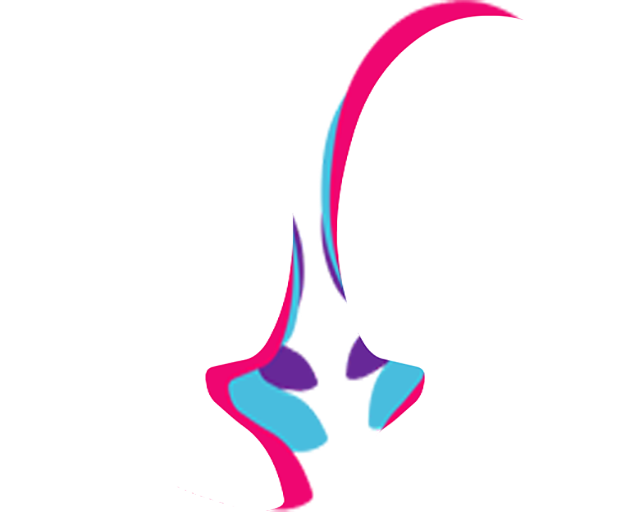بقلم: حسين روماني
“نصيبك في حياتك من حبيب.. نصيبك في منامك من خيال”، بيت شعر للمتنبي لم يعد يمرّ مرور الكرام على مسامعنا، بعد أن قاله “أمجد” في الغفران، عقب آخر الأحلام الكبيرة التي طويناها مع “عمر”، حيث مضى بعدها يبحث عما يعزّي به نفسه بين الأيام، أخذت بنا نحو “حسن” وتغريبته عن حبه الذي سرقته قسوة الحياة، ليحرق قلوبنا “عامر” وأسرار المدينة التي اكتوى بنار الحب فيها، فكوت جسده ألسنة الطمع والنار، جميعها مشاهد لشخصيات لم تسكن البال كصورة فقط، بل امتلأت معها كثير من المشاعر وحقول من الإحساس، أتقن حفرها في ذاكرتنا نجم واحد، إنه العاشق، باسل خياط.

شخصيات عاشقة
جسد الخياط العديد من الأدوار التي كانت طرفاً في قصة حب، تعامل مع نصوص نسجت هذه المشاعر ضمن حكايا محلية الصنع، ووقف أمام المخرجين باختلاف أسمائهم، أبدع في استخدام أدواته وقدم دور العاشق كل مرة بلون مختلف، وإن كان للحب درجات فبطلنا له خطواته في الماضي الجميل الذي لا نستطيع نسيانه كما هو أيضاً، أولها “عامر” في أسرار المدينة، الحب المتهور الممزوج بالقوة والدمع، ابن الطبقة الوسطى الذي هبط عليه كنز من المال، فعاد بعد سفر فقط كي يكون مع حبه الأول، الذي بكاه، بدمع وردة وراء سياج، ليلة زواجه لكنه لم ينساه، فيحترق قلبه قبل جسده بنار الحياة ووقودها طمع الآخرين.

ذاك الدور الذي أداه أمام كاميرا المخرج هشام شربتجي كان بمثابة جلسة تعارف مع الجمهور، بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية بسنة، لتأتي المحطة التالية مع الراحل حاتم علي الذي يعني لباسل الكثير، بعملين مختلفين في عام واحد، الأول جعلنا حاتم علي نرى دمشق بعيونه كما جعلنا نرى باسل خياط بدور مختلف، فكان “عمر” في “أحلام كبيرة”، ابن الحارة الدمشقية، الشاب المجتهد في علمه لم يكن في لحظة منطق عندما أحب فتاة أكبر منه سناً وتخالفه الدين، فتركها في طائرة سفر مع كثير من أحلامه ومضى في طرق الحياة بهذه المدينة، حتى التقيا بعد سنوات، فلم يكن يريد سوى لحظة وداع لتكتمل القصة بالنسبة إليه، أما العمل الثاني فكان بمثابة وثيقة تاريخية لـ “التغريبة الفلسطينية”، فنرى “حسن” صبي القرية الذي مات عندما قررت العائلة إعطاء فرصة التعليم لأخيه “علي”، وانصرف يعمل في الأرض وهو طفل، ليدافع عنها من قسوة الاحتلال وهو شاب، “حسن” الذي أحب “جميلة” متحدياً بشجاعته العادات والتقاليد، ليراها تموت أمامه برصاصة استقرت روحه قبل أن تستقر في جسدها، ظل يسقي شتلة الزيتون التي زرعها على القبر من دموعه حتى استشهد.

ومع تجربة ثالثة بين باسل وحاتم كانت “الغفران”، ذهبت بشخصية “أمجد” الانسان المليء بكتلة من المشاعر لـ “عزة”، حب الطفولة والمراهقة، ذلك الإحساس الذي يلقي بظلاله على القلب مرة في العمر، ورغم تكلله بالارتباط والزواج، لم تكن تلك العاطفة متبادلة، فتبحث هي عن ثقب الانفصال، ويتمسك هو بوهم البقاء وقلبه لازال بها معلقاً، حتى تقسو عليه الأيام لتلمح عينه عيناها بعد غياب، وهي متزوجة، ليخبئ براحتيه دموع لحظة كان كل الوقت قلقاً من أن تأتي، وحبيبته شِبهُ تحيا.
لا يؤمن بالحب
على الصعيد الشخصي، دق قلب باسل بعلاقة في العشرينات، انتهت بعد 6 سنوات، لكنه لم يستطع أن يتركه إحساس أن تلك الفتاة موجودة في كل أغنية يسمعها، صورة العينان الملونتان الممتلئتان بالشمس لم تتركه لحظة في كل مكان يذهب إليه، ليتخيلها تنظر إليه وهي تبتسم، ليلجأ إلى طبيب نفسي، ويكتشف أنها حالة من “النوستالجيا” لفتاة صغيرة كان يغمره الفرح وهو ينتظر معها باص المدرسة في طفولته، ويؤكد بطلنا أنه لا ينظر إلى الحب بالأقواس التي وضعتها العلاقات حوله، إنما يؤمن بشيء وجودي في العلاقات أقوى من الحب، يصف علاقته بزوجته ناهد كعلاقة راقية عنوانها الوجود، فوجوده من وجودها، ابتسامته من ابتسامتها، يرى بأن علاقات البشر أحياناً تنطلق بكثير من “الغرور”، بمعنى أنا أحبك عندما تقوم بالكثير من الأفعال الجميلة من أجلي، لكن أن أحبك عندما تفعل لنفسك وتحقق من أجلها الكثير، هكذا يرى باسل تلك المشاعر، وما الحب سوى ضعف، والوجود قوة.

أخيراً..
لأنه مميز لا يكرر نفسه، لم نعد نجده يقترب من هذا النمط من الشخصيات، بل يجد المتعة في تجسيد أدوار مليئة بالبعد النفسي وما آلات إليه، كالقنبلة التي رماها في “قيد مجهول” مؤخراً، وقبلها العديد من الأعمال المشتركة الموزّعة بين مصر ولبنان.