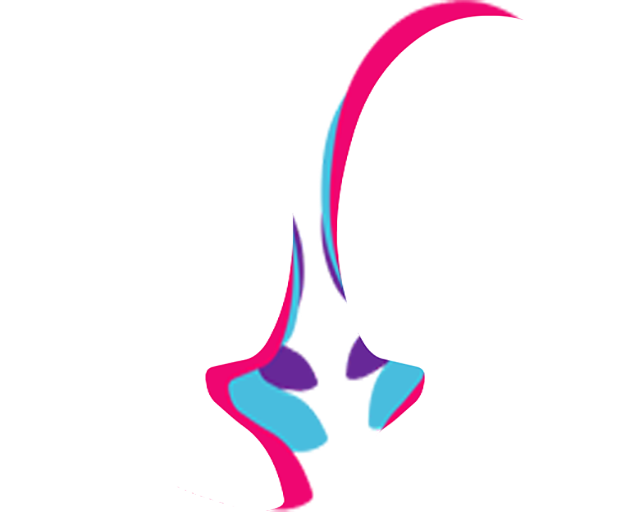بقلم: علاء سمّاك
إذا ما أخذ العمل الدرامي على عاتقه تصوير حياة الناس، وهذا ما خلقت “دراما زمان” لأجله، تلك التي نتغنى بها وتتسابق القنوات لعرضها عشرات المرات بدون ملل، والتي مهد أبطالها الطريق لدراما اليوم، فــ غسان جبري دريد لحام ونهاد قلعي وغيرهم من جنود الفن الذي أينع بسلاحهم، دافعوا بالدراما عن قضايا عصرهم آنذاك، لعلها تحاكي قضايا اليوم، لكن أين هي هذه الدراما اليوم؟ وما مدى اسهامها في قضايا عصرنا الآن؟
مفارقة وتوازن:
لن أخوض فيما سبق الآن فنحن لسنا في الهند، – وإن كانت الدراما الهندية هي جزء من خطة الحكومة في تطوير المجتمع-، وإنما سأدخل في حناياه، فبالإضافة الى تحقيق المتعة للمشاهد، يصبح من المفترض أن يكون العمل الدرامي محفوفاً بمجموعة من القضايا والذي ينبغي تناولها بالضرورة.
وتكمن أهمية البناء الدرامي للنص في تناول القضية المجتمعية من حيث ولادتها وتكوينها، ومن حيث هندسة أفكارها وكيفية تشكلها وتجميع عناصرها، وتوحدها في عمل فني متكامل، لا نقول إنه تقع على الدراما مسؤولية معالجة هذه القضية لكن تناولها وطرح المشكلة سعياً لحلها يعتبر إضافة للعمل وأحد مهامه.
وعندما يتم التطرق الى الحديث عن قضايا المجتمع والانطلاق من عناصر المشهد الدرامي الذي يضم بشكل أساسي البيئة أو الفترة الزمنية التي تدور فيه أحداث العمل، يودي بنا إلى الحديث عن الأعمال التي جاءت ملامحها الدرامية إما متوازنة أو طاغية على رسالة العمل الإنسانية.
ففي الكوميديا مثلاً، لا يمكننا الجلد بأعمال د. ممدوح حماده وعمل كوميدي كـ “ضيعة ضايعة”، وعلى أهميته،قد تناول أحداثه بطريقة واضحة لم تعلُ على رسالة العمل الإنسانية، باعتباره عمل يتناول توق الانسان المعاصر التخلص من كل أنواع العبودية سواء من السلطة أو من التكنولوجيا، وحنينه للعودة إلى الطبيعة، فهو عمل كوميدي في فلك انساني بحت.
بيئة معينة وبيئة معيقة:
هنا يستحضرني جداً ما تناوله “مازن طه” و “المثنى صبح” أثناء تصوير مسلسل “سكر وسط” إنتاج 2013 الذي كان أحد مساعيه هو تناول آثار السكن العشوائي وانتهاكاته، والبيئة السلبية التي ستولد سلوك سلبي للقاطنين والمتأثرين بها بالنتيجة.
لكن ذلك لم يبرز واضحاً لدى المشاهد نتيجة الرؤية الاخراجية غير الموجهة، فبدا تصوير العمل في بيئة عشوائية كناحية سلبية لا جدوى درامية منه، فهو بعيد مثلاً عن ميدان حسن سامي يوسف في مسلسل “الانتظار” الذي يعد فاتحة لأعمال السكن العشوائي في الدراما السورية، فعرضَ هموم ومشاكل هذه الطبقة الاجتماعية بقالب درامي ملفت، فكان تصوير البيئة أهم عناصر المشهد ومكوناته، جاعلاً أهداف العمل ومعالجة القضية بحد ذاتها طاغياً على فكرة تصوير نواحي سلبية للمشاهد العربي خارج سوريا.
ولا ننسى سمير حسين و “قاع المدينة” الذي تناول حياة الطبقة المهمشة والمنسية وسط سكن عشوائي بعناصر واضحة.
أما في التاريخ فمن الصائب أن يمدح الكاتب عبد الغني حمزة بـ “أعقل المجانين” فطنة العرب وحكمتهم من خلال تصوير العمل ببيئة تاريخية في زمن الخليفة هارون الرشيد،
وكل هذه الاعمال على سبيل المثال لا الحصر وصلت الى المشاهد بالرؤية الاخراجية ذاتها التي تصورها المخرج أو كاتب العمل..، فهل نالت هذه الدراما ما سعت اليه؟ وهل أوصلت فكرة الطرح الى المجتمع؟
الطبق المسموم
وهذا كله مختلف تماماً عن فكرة التجارة والتشويه بالمجتمع السوري فتصوير العمل في بيئة مخالفة لسياق القصة الدرامية وتقديمه للمجتمع هو تشويه للتاريخ أو للتراث الذي قد يبدو مخالفاً للواقع وقد يرسم صورة للمشاهد العربي بعيدة عن مُثل السوريين وقيمهم، فتترك انطباعاً هجيناً، بحيث لا يكون هناك جدوى هادفة من اسقاط أحداث معينة على بيئة غريبة عنها، وتصوير العمل على أنه يحدث ضمن هذه البيئة، كما فعلت الكثير من الشركات المنتجة التي تسابقت لتصوير أعمالها ضمن بيئة قد لا تخدم أهداف العمل الذي كتب لأجله، وإنما لأهداف تسويقية!
ولم يكن الكاتب مروان قاووق السباق لذلك، لكن إقدامه على تصوير “وردة شامية” الفارغ من اسمه حتى، والمشوه لكلمات في صميم المجتمع السوري، والمليء بالجرائم بفكرة مقتبسة من تاريخ عربي آخر، فيصار إلى فعلها ضمن حارة دمشقية عريقة، والتي بررها قاووق بـ “كسر نمطية” جاعلاً العمل أقرب للفانتازيا من الواقع، فما خدمت البيئة الشامية سيرورة العمل ولا اقتربت من تاريخ المكان الذي صور به، بل شوهت الثقافة والأخلاق التي نمت في كل بيت سوري.
وإلا فما الجدوى الفنية أو المجتمعية أو الدرامية التي بغا الكاتب والمخرج إيصالها من خلط “الحابل بالنابل” وكأن العمل الدرامي هو نتيجة رحلة تسوق في سوق ملابس يمكنك “التلبيق” كيفما شئت دون أي اعتبارات ثم تأتي بالنجوم ليلبسوا العمل استعداداً لترويجه.
يبقى هناك فرقاً واضحاً بين أن تكرس البيئة لتخدم العمل الدرامي من خلال تصوير جوانب أرادها الكاتب من ذلك، وبين أن تستغل البيئة كـ ظاهرة اجتماعية لا هدف منها سوى استجرار عطف المشاهد أو تحقيق المتعة أو ركوب موجة الرواج الفني لنوع معين من الأعمال.
ونرى ذلك بوضوح في موسم رمضان 2013 وفي أوج تألق أجزاء باب الحارة الذي ضم في طياته بعضاً من قيم السوريين الأصيلة الذي اشتهر بها بسام الملا، توالت أعمال البيئة الشامية وتم استثمار السوق من قبل منتجي المسلسلات للتلفزيونية السورية ومخرجيها الذين لا يترددوا بالبحث عن كل ظاهرة جديدة لتقديمها للمشاهد.. كما نشهد أعمال “البان أراب” هذه الفترة، والتي “تحلق” بأغلبها في فضاء القنوات دون أي هدف أو قرب من الواقع السوري إن لم يكن العربي.
نأمل في ولادة دراما جديدة، حقيقية وعبقرية في تجسيد عناصرها جُل تجسيد.. بركي منحكي دراما!