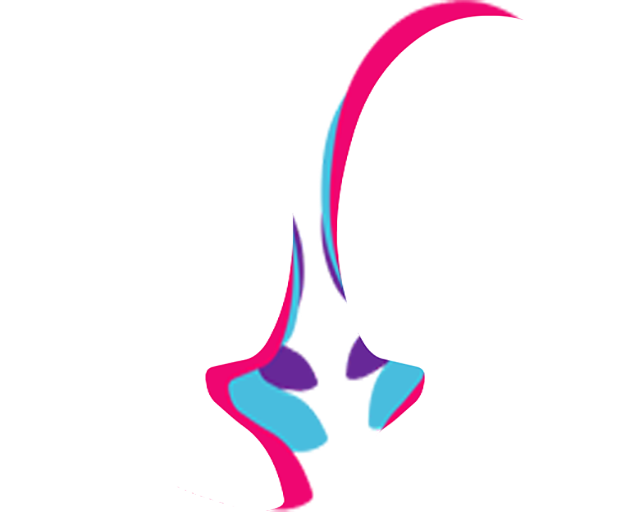لم تبخل دمشقُ يوماً على قاطنيها في أن تمنحهم من ثقافتها وتاريخها الكثير، لكن يبدو أن البُخلَ الثقافي الحقيقي بدا واضحاً في بعض العروض التي قُدِّمَت بالمسرح والسينما ضمن فعاليات مهرجان دمشق الثقافي وإليكم أبرزها :
تقرير: جوان ملا
فيلم حنين الذاكرة قد لا يبقى في الذاكرة

في تجربة جديدة قدمتها المؤسسة العامة للسينما، افتُتِحَ فيلم “حنين الذاكرة” في سينما سيتي بدمشق، والجديد أن الفيلم قام بإخراجه أربعة شباب هم “يزن أنزور، علي الماغوط، سيمون صفية، كوثر معراوي” بينما كتبه “سامر محمد اسماعيل”.
يدخل الفيلم في تفاصيل النكسات التي عاشتها سوريا تاريخياً بدءاً من احتلال القنيطرة عام 1967 ثم حرب تشرين وتطرَّقَ بشكل غير مباشر تماماً لحركة الإخوان المسلمين في سوريا ثم الحرب في لبنان والنزوح اللبناني ومنه إلى الحرب العراقية الكويتية فالغزو الأمريكي للعراق والنزوح العراقي إلى سوريا وصولاً إلى الحرب السورية وتداعياتها.
فصول الحكاية الأربعة باتت متباينة الإيقاع بين الصعود والهبوط، فقد استطاع يزن أنزور وعلي الماغوط إمساك الطرف المشوّق في القصة وسرده بصورة لونية جيدة ولقطات سينمائية ملفتة، الأمر الذي لم يحدث مع سيمون صفية وكوثر معراوي، فقد انقلبت الصورة بطيئة وباردة مع فصل سيمون “لا أحب اللون الأحمر” وبدا متأثراً بالأفلام الكلاسيكية الإيطالية أو الفرنسية القديمة مع مشاهد باهتة لا تتناسب أصلاً مع شخصيات الفيلم، فجاءت القصة وكأنها منفصلة تماماً عن باقي الأحداث، كذلك الأمر في فصل كوثر معراوي “العودة” الذي بان وكأنه دراما تلفزيونية أكثر من كونه سينمائي، وزاد من ذلك النهاية غير المبررة والتي نزعت أي نظرة تفاؤلية من فحوى الفيلم.
ويعيب على المخرحين الأربعة دون استثناء أنهم لم يعتنوا بالتفاصيل البتة، ومن الواضح تماماً أنهم لم يقيموا ورشة عمل يتحاورون فيها عن النص أو على الأقل يدرسون الشخصيات، بل بدا وكأن كل واحدٍ منهم قد عمل بمفرده، فظهر الفيلم بصورة مشتتة، بلا روح واحدة، مليء بالأخطاء التي اعترت الديكور، والملابس، وحتى الشخصيات، فمثلاً ظهر الفنان “جهاد الزغبي” في أول الفيلم بعمره الطبيعي الخمسيني أو ربما نهاية الأربعينات في أسوأ الأحوال – أي عام 1967- ، وبعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً مازال “جهاد الزغبي” كما هو دون أي تغيير حتى في “الجاكيت” الذي يلبسه، لم يَشِخْ أو ينحني ظهره أو يموت حتى، بل بقي بكامل قوته من عام 1967 حتى 2013 بل وإن الشخصية الأصغر الذي لعب دورها “لجين اسماعيل” كبرت وشاخت وماتت قبله، وكأن الزغبي قد شرب “إكسير الحياة”، كذلك الأمر مع “سعد مينة” الذي مرت عليه السنون دون أن يتغير في ملامحه شيء جوهري أو تظهر تجعيدة على وجهه، بل ظل عنيفاً قوياً حتى الفصل الأخير من الفيلم، وبقي حذاؤه العكسري البني لامعاً دائماً رغم قضاء معظم وقته متدرباً في المعسكر بين الغابات والطين، عداكم عن تشغيل المحطات التلفزيونية على شاشة التلفاز في المنزل الذي تدور فيه أحداث العمل دون أن يكون “الريسيفر” يعمل أصلاً، أيضاً شاهدنا جثة واقعة تحت الدمار تتنفس!!.

رغم ذلك أثبت الفنانون الشباب أنفسهم في العديد من اللقطات بالفيلم مثل “مؤيد الخراط” الذي ظهر بمنظر مختلف كلياً عن شخصيته ونجح فيها و”سيرينا محمد” التي استطاعت الإيحاء بالشخصية القوية المتسلطة، وكذلك “مروة الأطرش” رغم ظهورها البسيط، كما برز “ياسر سلمون” كموهبة قادمة بقوة تحتاج فرصة أكبر للظهور لتعبّر عن كمية الإبداع الذي صنعها في أدائه الحقيقي، أما “لجين اسماعيل” ورغم إبداعه في كافة الأدوار التي قام بها إلا أن النقصان في شخصيته كان واضحاً ولم يبدُ هو لجين نفسه الذي اعتدنا على أدائه المبهِر في كل مرة مسرحياً أو سينمائياً.
المسرح الراقص يتشتت

شهد العرض المسرحي الراقص “غرفة تحت الصفر” من تأليف وإخراج سعيد حناوي وكريوغراف محمد حلبي وبطولة فرقة خُطا للمسرح الراقص حالات نفسية صعبة تم التعبير عنها من خلال الرقص الذي كان جيداً إجمالاً لولا بعض التشتت الذي شاب بعض الراقصين تحديداً في حركات عيونهم التي لم تكن مستقرة، أما القصص المطروحة في العرض فكانت مكررة مبتذلة ولا جديد فيها أبداً والحوار يقترب إلى الدراما التلفزيونية أكثر من كونه مسرحياً، فيشعر المشاهد وكأنه يتابع جزءاً جديداً من مسلسل “الرابوص” لِما في العرض من حالات شبيهة بشخصيات المسلسل، ليبتعد الحوار كل البعد عن خشبة المسرح ويضفي على حالات الرقص ضعفاً بدلاً من إشباعها.
مسرح الأطفال يعاني
على خشبة مسرح العرائس اكتظّ الأهالي مع أطفالهم لمشاهدة مسرحية “نمرود والأصدقاء” لكاتبتها ومخرجتها “فاتن ديركي”.
القصة كانت تتحدث عن “التنمر” والرفق بالحيوان في خطوة جميلة من الكاتبة لنبذ هذه الظاهرة المنتشرة بكثرة بين الأطفال، وحقيقةً كانت تجربة فاتن في الكتابة جيدة، لكن للأسف ومن الواضح أن مسرح الطفل مازال بحاجة لعناية كبيرة جداً، فالمكان المختنق لم يفسح للأطفال مجال متابعة المسرحية بحرية كاملة، فضلاً عن الضعف بتقنيات الإضاءة والصوت وتسجيل الأغاني الذي لم يصل للآذان والأذهان بشكل واضح، بالإضافة للتنظيم السيئ، فكان التشتت سيد الموقف رغم جمالية الحبكة القصصية للعرض، وهدفها، ورغم ذلك تحدثت فاتن ديركي لموقعنا عن سعادتها بهذا العمل والإقبال الشديد عليه، وقالت إنها قررت أن تبدأ أولى نصوصها على المسرح مع الطفل لأنها تعتبره نواة أي أسرة ومجتمع.
جحيم مسرحية الخروج من الجنة

من الخاطئ والمعيب أن نقول عن مسرحية “الخروج من الجنة” لمخرجها “فراس المقبل” أنها مسرحية أساساً، بل هي عبارة عن مجموعة شباب وفتيات – ظهرنَ وهنّ محجبات “دون مبرر منطقي” – دون أن يملك أحدٌ فيهم للأسف أي أدوات تمثيلية مقنعة، ولا مخارج حروف صحيحة، بل أدوا أدوارهم بشكل ساذج جداً لقصة طفولية باهتة وتقليدية لا تمتّ للمسرح بِصِلة.
أداء غير مقنع ونَصّ يترنح بين الفصحى واللهجة المحكية، ولا يُعرف مغزاه ولا ندري إن كان كوميديا سوداء أم دراما أو في أي تصنيف يمكن أن نصنّفه!.
لم يعتنِ المؤدون بالتفاصيل حتى، ولم يُظهِر ولا واحد أو واحدة فيهم أي موهبة تلمع قليلاً وتكون واضحة للجمهور، حتى لحية الشيخ بطل القصة كانت أقرب إلى “الإكستنشن” أكثر من كونها لحية، فبات العرض هزلياً هزيلاً، وبمجرد أن يتابع الجمهور بدايته سيدرك تماماً أنه وقع في الفخ، فيهرب ويمشي ليخرج إلى الجنة بدلاً من الجحيم الذي كان فيه.
والغريب أن وزارة الثقافة سمحت بأداء هكذا عرض في مهرجان دمشق الثقافي بمسرح دمشق الأكبر “الحمراء”!.
الطين الأحمر على وجوهنا

المونودراما من أصعب الأنواع التي يقدمها المسرح، كونه يرتكز على ممثل واحد، وأداء واحد، لذلك يتوجب على الممثل الذي يؤدي هذا النوع أن يكون متمكّناً جداً من أدواته وصوته وأن يخلق حالة حقيقية مع كل قطعة موجودة على خشبة المسرح ليشعر بها تماماً وكأنها إنسان حي مثله، كل هذا للأسف لم نجده في “لبابة صقر” بطلة عرض “الطين الأحمر” لمخرجه “سمير الطحان” والتي عُرِضت على مسرح القباني.
شابت المسرحية أخطاء كثيرة أولها إدخال فيديو مصوّر على المسرحية ضمن شاشة عرض لمَقاطع ليس لها لزوم حقيقةً، فوجود هذه المَشاهد لم يمنح الفرصة للجمهور كي يتخيل تفاصيل القصة التي تسردها لبابة وهي أهم حالة من الممكن أن يعيشها المتلقي على المسرح في عرض مونودرامي، فضلاً عن ذلك لم تقنِعْ صقر في أدائها الجمهور، فكانت جامدة بحركتها ولا تمتلك تلك الروح المسرحية الحقيقية، حتى وهي تغيّر شخصيتها لتمثّل حال أمها وأبيها اللذين تركتهما في الضيعة وهجرتهما بسبب حبها لصديقها في الجامعة، ظهر الأداء نفسه تقريباً فكانت شخصيتها “مريم” نفسها حين تحاول تقليد شخصية أمها وأبيها، ولم تستطع تقمصهما جيداً.
ومازال يتخلل العرض لقطات على الشاشة لصور من ماضيها عدا عن الرقصة التي بدت فجأة في الفيديو المصور وكأننا نتابع فيلم قصير.
وفي الأحداث تسقط قذيفة قريبة من مَشغل الرسم والنحت الذي تدور فيه القصة فتقع مريم على الأرض وحدها، لا يتأذى الديكور ولا المنحوتات ولا الرسوم ولا حتى زجاجة النبيذ، فكل شيء بقي على حاله بينما هي بكامل جسدها سقطت بسبب القذيفة!.
أما القصة فلم تكن بحاجة إلى كل هذه المعاناة التي تعتري مريم، فالقصة مكررة ومطروقة للمرة الألف، ولقد سبق وتابعنا كثيراً قصة الحبيبَين اللذَين يختلفان في الدين ولا يتزوجان بسبب ذلك، فيهاجر الشاب للخارج ويترك حبيبته التي تتفاجأ فجأة وبدون مقدمات أن صديقهما المشترك يحبها وهي كانت تظن أنه يحب صديقتها التي قُتِلت في الحرب أمام عينيها والتي بالمناسبة لم تدمع عينها لذكرها مع أنها ماتت بين يديها.
حيث يعبّر “حسام” عن حبه لمريم بتسجيل صوتي عبر “واتس أب” فينصعق الجمهور لهذا المبرر الأكثر من درامي وغير المنطقي وطريقة الطرح الساذجة، وتنصعق حتى بطلة العرض التي رفضت هذا الحُبّ وردّت على عرض العاشق المرسل بالـ”واتس أب” برسالة باللغة العربيةالفحصى تركتها في المَشغَل! لتقرر العودة لضيعتها إلى بيت أهلها هكذا ببساطة بعد خمس سنوات من الغياب، ليغيب مع هذه النهاية الطرح القوي بالإضافة للأداء المبهِر التي لا تتمتع به الفنانة الشابة “لبابة صقر” والتي يبدو أنها بحاجة أكبر للتمرين والتفاعل مع الأدوات المحيطة بها لتلمسَ حقيقة خشبة المسرح وتعرف ماهيتها.
بمهرجان دمشق الثقافي نجد أنفسَنا مازلنا بحاجة ماسة لتوطيد ثقافةٍ حقيقيةٍ نابعةٍ من أفكار قيّمة تُقَدَّم بأسلوب يرقى ويليق بهذه العاصمة الأقدم في العالم والتي مرّ عليها منذ نشأتها مجموعة من الثقافات والحضارات والتاريخ العريق، ونتساءل إن كان مازال بإمكاننا صناعة محتوى فني ثقافي نستطيع تصديره للعالم!.